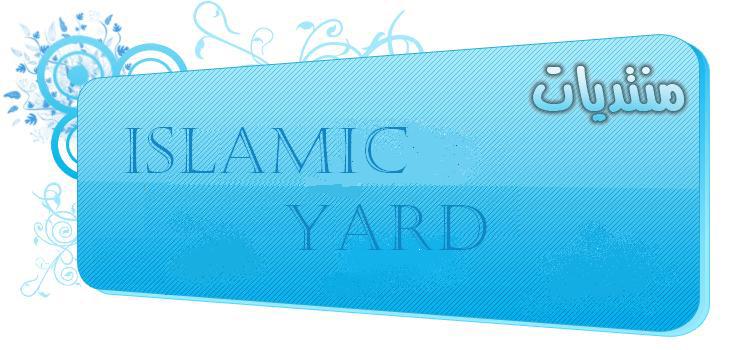أمرنا
الله تعالى بالدعوة إلى دينه، وأوجب على المسلمين أن يكون فيهم من يقوم بهذا
الواجب، ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾،
وقد فهم بعض العلماء أن هذا واجبٌ على الأمة كلها، وأن معنى الآية كما تقول للرجل
أريد منك أن تكون رجلاً، فهو يريد أن تكون الأمة كلها داعية إلى الله، ويؤيد ذلك
قوله تعالى: ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر﴾،
فجعل وصف الأمة كلها الأمر والنهي.
والله
تعالى لم يطلب منك أن تكون وحدك عبداً له، بل يريد أن يكون جميع الناس عباداً له،
فإذا حققت العبودية لله في نفسك، فحقق مراد الله بأن تكون سبباً في إيصال العبودية
إلى الناس، إلى الكافرين ليدلهم على الإيمان، وإلى المسلمين ليزيدهم قرباً
وعبودية.
والداعية
إلى الخير والحق يكون عادة أحرص على التحلي به والتقيد به، ليكون صادقاً في دعوته،
فإن من يدعو الناس إلى شيء ثم يفعل خلافه فإنه يكون كذاباً منفراً، يقول بلسان
شيئاً ويقول بحاله وأفعاله خلافَه.
وقد
حذر الله تعالى الداعية والآمر بالمعروف أن يأمر بالخير ويتركه، فقال: ﴿ أَتَأْمُرُونَ
النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ
أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: 44].
ولا
يفهم من هذا أن على الإنسان أن يترك الأمر بالمعروف إذا لم يكن يفعله، أو يترك
النهي إذا كان يفعل المنكر، بل هو حث على أن يعظ نفسه قبل غيره، وعلى الإنسان
واجبان: واجب فعل الخير وترك المنكر، وواجب الأمر والنهي، فإذا ترك الأول فليس ذلك
بعذر ليترك الثاني، وإنما هو دليل على ضعف تفكيره وعقله، فينبهه الله تعالى أن
يستعمل عقله: ﴿ أفلا تعقلون ﴾.
فالعاقل
يبدأ بنفسه فيصلحها ثم يجتهد في إصلاح غيره وتعليمه، وهذا ما يفهم من قوله تعالى:
﴿أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس ﴾، فالإنسان
يكون ببعده عن الإيمان والعمل الصالح كالميت ﴿ أومن كان ميتاً ﴾ فإذا آمن وصلح صار
حياً ﴿ فأحييناه ﴾ بأن أصبح صالحاً في نفسه سليماً قلبه، ثم
يُعطيه الله تعالى بعد ذلك نوراً خاصاً ليدعو غيره ﴿ وجعلنا له نوراً يمشي به في
الناس ﴾، فيصير أهلاً لدعوة الخَلْق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن كان لا
يملك النور لنفسه فكيف سيضيء لغيره.
وكأَنَّ
الآية تُذَكِّر المؤمن أن يعمل على إحياء نفسه قبل أن يجتهد في إحياء غيره، وكثير
من المتحمِّسين من شباب الأمة تجده يجتهد في الدعوة وهو بحاجة إلى تزكية وعلم
وعمل، إلى حدِّ أن قد يكون مرائياً في دعوته، وقد لا يستطيع أن يميز الإخلاص من
الرياء، فالصادق من هؤلاء ينتبه إلى نفسه فلا يغتر بدعوته ونشاطه، بل يراجع نفسه
ويبدأ بنفسه، ثم ينتقل بعد أن يعالج أمراضه ويزكي نفسه إلى غيره، فإذا اجتهد في
الدعوة بعد أن يزكي نفسه سيجد أثر دعوته أَعْظَمَ وأَبْرَكَ بكثير، وسيكون أخلص
فيه لله، وأبعدَ عن هوى النفس وعن التنافس الدنيوي وعن طلب الجاه والتعالي.
وكلما
كان الإنسان على بصيرة من الإيمان والعلم والهدى والتقوى والنور والفراسة
والإلهام؛ كلما كان أَقْدَرَ على الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
والتأثير في الناس، قال تعالى: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلى اللهِ عَلَى
بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف: 108].
وعلى
الداعية والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يُحسن الخطاب، فيختار ما يؤثر في
الناس وما يقنعهم وما يفتح قلوبهم ويحبب الدين إليهم، قال تعالى: ﴿ ادع إلى سبيل
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾، ﴿ وقولوا للناس حسناً ﴾، ﴿
فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى ﴾، فإذا كان المستكبر فرعون الذي يدعي
الألوهية يقال له القول اللين، فكيف بغيره، وكيف بالمسلم، نجد كثيراً من الدعاة
يلين القول للكافر، ويشتد على المسلم إذا خالفه أو أخطأ أو ابتدع، والواجب في حق
الداعية حسن الخطاب واللين ﴿ ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ﴾، ولا يخلو
أن تكون هناك حالات تحتاج إلى شدة وتعنيف، لكنها ليست هي الأصل.
وينبغي
أن يكون عند الداعية والآمر والناهي حكمة، يعرف بها كيف يقدر الأمور وخطورتها وما
هو الأولى أن يبدأ به من الدعوة والإنكار، وما يمكن أن يؤدي فيه الإنكار إلى منكر
أكبر منه، وما هو الوقت الأنسب والأسلوب الأصلح للدعوة والإنكار.
والمنكَر
الذي ينبغي أن يحرص المؤمن على إنكاره ما كان منكراً بلا خلاف بين العلماء، أما
المسائل التي اختلف فيها العلماء لاختلاف النظر أو اختلاف الأدلة أو الاختلاف في
تصحيحها أو فهمها أو نحو ذلك؛ فلا ينبغي أن نحمل الناس عليه حملاً، وإن جاز لنا أن
نعلمهم ما نظنه من ذلك صحيحاً ونبين لهم حجتنا وننصحهم به، من غير أن نعنفهم على
خلافه، ولا أن نحقِّر من قال بخلافه من العلماء.
وأقل
الإنكار على المنكَرِ إنكار القلب، إذا عجز الإنسان عن الإنكار بالكلام، أو لم يكن
له سلطة ليغير بيده، « من رآى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه،
فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»
([وحدهم المشرفون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط])،
وفائدة الإنكار القلبي أنه يحفظ الإنسان به نفسه عن أن يتهاون في المنكر، لأنه إذا
اعتاد رؤية المنكر ولم يتذكر فساده فإنه يهون في النفس فلا ترى به بأس، وربما
يقودها ذلك إلى الوقوع في المنكر والمعصية، ولا شك أن له أثراً طيباً لذلك عده
النبي r نوعاً من التغيير
﴿ فبقلبه ﴾، وسماه جهاداً: « ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن »
([وحدهم المشرفون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]).
وكما
للأمر بالمعروف وتغيير المنكر أثر على فاعله؛ فله أثر على المجتمع كبير، ذلك أن
أهل المنكر والباطل والإفساد إذا رأوا أنه لا ينكر أحدٌ عليهم؛ زاد منكرهم، ويظنه
الناس خيراً أو أمراً معتاداً، لما يرون من وجوده وعدم إنكار أحد عليه، فيسري
الباطل في المجتمع، ويتهاون فيه الناس، وإن وُجِدَ من يُنكر المنكر عَرَف الناس
أنه منكر، واستنكروه، وخجل منه الناس ومن يفعله، فيكون ذلك سبباً في قلة الباطل
وسبباً في استحياء الناس من فعله فيخفونه، بل ويحاربونه، فلا ينتشر ولا يزداد.
والأمر
بالمعروف إشاعة للمعروف والخير بين المجتمع، وتشجيع عليه، وإبقاء له، وتثبيت
للمجتمع عليه.
ومن واجب الأمة المسلمة دولاً وعلماءَ
وشعوباً أن يُعِدُّوا عدداً كافياً من العلماء، يَكفُون لنشر العلم الحق، ويقومون
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، ويكونون محل ثقة الأمة والشعوب بما
عندهم من التزكية والحكمة والرسوخ في العلم.
[وحدهم المشرفون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]([1]) أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري t رقم
49.
[وحدهم المشرفون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]([2]) أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود t رقم
50.